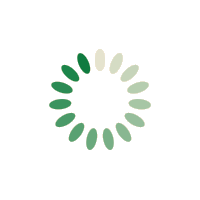
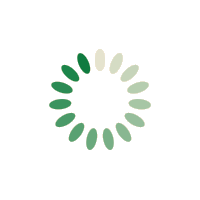


إقامة الدولة تمثّل لحظة إنجازها تجسيداً لإرادة أمة وتعبيراً عنها، أي حال تطابق حدود الدولة مع حدود الأمة، بحيث تصبح الدولة التجسيد السياسي للأمة، وقد تكون الدولة تلبية لطموح أو حاجة فئة اجتماعية معينة. وفي كل الأحوال، يبقى الجهاز الإداري للدولة ـ الحكومة، أمام مسئولية تاريخية لتأمين مصير الدولة نفسها، وهي الشروع في تدشين أسس علاقة جديدة بين المجتمع والسلطة، أي الانتقال من الفئة الى الأمة، ومن الخاص الى العام، أي إرساء أساس المواطنة كإطار يتخطى الواقع القائم بتنوعه الإثني والثقافي والديني لجهة الإفادة منه ـ أي من هذا التنوع في بناء رابطة وطنية عليا تشد السكان بالدولة.
الانتقال من الفئة الى الأمة يعني، بكلمات أخرى، تحقيقاً عملية دمج واسعة النطاق لهويات وثقافات ومشاعر وروابط تاريخية في مصهر الدولة وصولاً الى انشاء ما يعرف بـ "الحكومة التمثيلية" كترجمة أمينة عن الواقع التعددي في بلد ما وكإحترام لخصوصيات جماعاته المتنوعة واعتراف بحقوقها السياسية المتساوية.
بلادنا تحتضن جماعات متعددة مذهبياً وقبلياً وإثنياً، وكان قيام الدولة عام 1932 قد أدى الى إلغاء الهويات الخاصة رجاء تصنيع هوية وطنية جامعة، وتشكيل علاقة الدولة بالسكان المنضوين حديثاً في الدولة الناشئة على أساس المواطنة بالمعنى المليء للكلمة، أي بما تحمل من قيم المساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع، وتالياً اعتبار المواطنة وحدها المعيار الذي يجب الاحتكام اليه، وليس المذهب أو القبيلة أو المنطقة.
ما جرى منذ نشأة الدولة أن السلطة بقيت بمواصفات خاصة في هويتها وانتمائها الاقليمي ونزوعها المذهبي، بل استعملت هذه الخصائص في أحيان كثيرة للانقضاض على ما تفترضه هويات وانتماءات ونزوعات مناوئة. أي حين فشلت السلطة في صناعة هوية وطنية جامعة وأرادت إستعمال مكونات خاصة لصناعة ما يتوهم بكونها هوية وطنية وأسس لمواطنة مزعومة، قررت أن تخوض معركة شرسة مع جماعات عديدة، بذريعة التشكيك في ولائها للدولة أو من أجل محاولات التذويب السياسي أو المذهبي.
الوثيقة الوطنية للإصلاح المرفوعة الى ولي العهد من قبل نخبة من دعاة الإصلاح، تنبّهت بصورة واضحة لاختلال أسس العلاقة بين المجتمع والسلطة في المملكة، وقدّمت ما يمكن وصفه تشخيصاً دقيقاً لأزمة الوطن الذي لم تنتجه الدولة بعد، وقدّمت ـ الوثيقة تصوّر حل جذري في مسعى لإعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة على أساس المواطنة الكاملة.
المواطنة في الادراك السياسي للسلطة تتساوى مع الولاء لها، ولكن حين تأخذ معانيها الحقيقية كما وردت في الفكر الدستوري الحديث، بما تستبطن من مساواة في الحقوق والواجبات تصبح المواطنة قضية مرفوضة، وتثير لغطاً أيديولوجياً عارماً يتجه تحديداً للجحود بها. وعلى أية حال، فإن السياق الذي تثار فيه قضية المواطنة يولّد خلافاً حاداً نظراً للانطباعات المتباينة التي يخلقها المصطلح. وفي بلد يفتقر الى دستور مكتوب أو حتى تقاليد أو ثقافة سياسية يرجع اليها الأفراد للتعامل مع الخلاف حول الجوانب النظرية والعملية لهذا المصطلح، فإن التفسيرات الواردة ستخضع للاجتهادات الفردية والجماعية. فمن وجهة النظر الدينية الرسمية، فإن المواطنة الحاملة لمعنى المساواة تتناقض والمعتقد الديني القائم على أساس أن أتباع المذهب الرسمي لا يمكن أن يتساووا في الحقوق والواجبات مع أتباع المذاهب الأخرى المصنفين دينياً في خانة المشركين وأهل البدع، ويستندون في ذلك على الآية الكريمة (أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون) وعلى الآية الكريمة الأخرى: (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون).
وبطبيعة الحال، فإن تحقق مفهوم المواطنة يتوقف على وجود وطن يشعر كل فرد فيه بالفخر للانتماء العاطفي التلقائي اليه. هذا الوطن لم يخلق بعد، لأن هناك من يرى بأن مفهوم الوطنية كمعادل أيديولوجي للقومية يناقض مفهوم الأمة الاسلامية التي يراد اختزالها في فئة مذهبية محدودة، وحين يتم تجريد الأبعاد الايديولوجية من مفهوم الوطنية، هناك من يضخ مقولات تحريضية يراد منها تأكيد مفهوم خاص للوطن، يعكسه أولاً المدعى التاريخي للعائلة المالكة والمدعى الأيديولوجي للمذهب الرسمي كممثل مزعوم عن الإسلام الصحيح، وثانياً التصريحات الرسمية والتعبيرات الفولوكلورية، التي تترجم رؤية الحكومة لرعاياها، كتصنيف السكان على أساس المذهب والمنطقة والقبيلة، فالروافض (الوصف القدحي في سكان منطقة الأحساء والقطيف وغيرهما) في الشرقية، والمتصوفة وطرش البحر في الحجاز، وصفر 7 في الجنوب، والخضيري في نجد، هذا التصنيف لم يكن منتجاً شعبياً بل مصدره السلطة وأجهزتها وسياساتها أيضاً.
إن تصنيفاً كهذا من شأنه إشاعة الكراهية بين سكان البلد الواحد، ومن شأنه أيضاً خلق فجوة عميقة بين الدولة والغالبية العظمى من السكان، وفي حال كهذه، يصعب الحديث حينئذ عن وطن، فالوطن شعور داخلي عميق بالحب والعطاء يغمر المنتمين اليه، ولا يمكن لوطن أن يصنعه متخاصمون مقهورون متنافرون، كما لا يوجد وطن يعذّب المنتمين اليه ويقدح فيهم، فلو كان وطناً لكف عن إيذاء من ينتسبون اليه.
وسنسوق هنا مثال جزء من هذا البلد الذي لا يجب إغفاله، وهو الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية، فهي تمثل المعاناة في أشد صورها قسوة، ويظهر الإختلال الوظيفي للدولة كراعية لمن تسوس، وأخيراً يعكس غياب الوطن الذي نبحث عنه جميعاً. ولا يجب إعارة إهتمامنا الى من يرون في طرح موضوع الشيعة نزوعاً طائفياً، فهذا ما يراد لنا دائماً إغفاله، لأنه إغفال لمشكلات الدولة واختلالاتها. ونفتح الملف الشيعي هنا ليكون مقدمة لملفات أخرى تمثل جميعاً قضايا الوطن ويجب أن يحملها الجميع، بل أن فتح الملفات الساخنة هو المدخل الصحيح لمعالجة أزمة الدولة وهو الأساس الذي يبنى عليه الوطن، وهو أيضاً دورة تأهيلية لمشاعرنا الوطنية وإنماءً لها، وحينئذ لا يشعر المواطن في الحجاز بالحرج والريب في دفاعه عن حقوق مواطنيه من الطائفة الشيعية، ولا يتحسس الشيعي في المنطقة الشرقية من الإسهام في رفع الضيم عن أخوانه في الحجاز، ولا يخجل أهل الجنوب من مطالبة الحكومة بتحسين ظروف مواطنيهم في الشمال أو حتى في وسط نجد، بل وأكثر من ذلك، لا يتردد أتباع المذاهب الحنفية والمالكية والشيعة الإمامية في الدفاع عن المضطهدين من أتباع المذهب الحنبلي.
فثمة مقصد نبيل إذن من فتح الملفات الساخنة وهو توفير قاعدة معلوماتية للمواطنين، فكثير من قصص المعاناة التي تعيشها بعض الجماعات المنضوية تحت هذه الدولة مجهولة، فمازال على سبيل المثال موضوع "البدون" في هذا البلد، قضية مكبوتة تماماً ولا يعلم بها سوى فئة محدودة من الناس.
وعودة للسياق الأصلي، فإن مثال الطائفة الشيعية كما يستحق من تأمل على المستوى الوطني يسترعي مراجعة السياسات العامة التي إتبعتها الدولة مع أبناء هذه الطائفة، وهي سياسات تتلخّص في التعبير الشيعي اليومي في وصف "التمييز الطائفي"، وهو توصيف دقيق. فسياسات التمييز الطائفي يجري تطبيقها على أبناء الطائفة الشيعية في مجالات التعليم والتوظيف والخدمات العامة، والحقوق الدينية والثقافية وصولاً الى التمثيل السياسي. فمازالت هناك سياسات مرسومة من قبل الدولة ويجري تطبيقها من قبل العاملين في أجهزتها تتجه جميعاً لفرض قيود صارمة على قبول الطلاب الشيعة في الجامعات، وتوظيفهم في الشركات النفطية وغيرها. وهذه السياسات لم تكن وليدة أزمة التعليم والتوظيف الراهنة، بل تمتد لنحو عقدين من الزمن وربما أكثر، حتى قيل بأن الشيعة في زمن الطفرة النفطية ربحوا السهم الأقل، وفي وقت الأزمة تكبدوا المعاناة الأشد.
حقوقهم الدينية مازالت غير مكفولة أو مضمونة من قبل الدولة، وتشهد مدن الشيعة وقراها استنفاراً أمنياً سنوياً خلال شهري محرم ورمضان، وفي نهاية كل مناسبة دينية هناك حملة اعتقالات ومصادرات وتحقيقات، فيعتقل من يوجد بحوزته كتاب أو شريط ديني، وتصادر الكتب والاشرطة، فيما يخضع بعض الخطباء لعمليات تحقيق مهينة أحياناً بخصوص المضامين السياسية لخطاباتهم الدينية. وعلاوة على ذلك، فمازال ملف القضاء والمحكمة الجعفرية الشيعية لم يتم حسمه حتى الآن، فالمواطن الشيعي لا يتمتع بحقوق قضائية متساوية في القضاء الرسمي، فشهادته مجروحة كونه شيعياً فحسب، وأن محكمته لا تتمتع بكامل الصلاحيات كما نظيراتها، بل هناك ميول شديدة وسط بعض الأوسط الدينية والرسمية الى إلغاء المحكمة الجعفرية أو إجهاض دورها القضائي عبر إلحاقها بالكامل بمحكمة أخرى مكتملة السلطة والصلاحية.
وحال كهذا يخبر عنه التمثيل السياسي للطائفة الشيعية، فمنذ نشأة الدولة وحتى الآن لم يتم تسليم شيعي واحد حقيبة وزارية أو حتى تعيينه وكيل وزارة، وحتى وقت قريب لم يكن هناك شيعي واحد بين طاقم السفراء، ومازالت حصتهم في الشورى ومجلس المناطق تدنو كثيراً الى دون حجمهم العددي. فمع قبول تمثيل الشيعة بنسبة 10 بالمئة من إجمالي السكان، فإن نصيبهم السياسي هذا إذا أردنا إتباع التمثيل العددي أو النسبي في الجهاز الإداري للدولة، يكون على النحو التالي: 2 ـ 3 وزراء، و12 عضواً في مجلس الشورى، وثلثي أعضاء مجلس المناطق في المنطقة الشرقية. وما يقال عن الشيعة في موضوع التمثيل السياسي ينسحب أيضاً وبنفس القدر على الفئات الاجتماعية الأخرى.
هذه الصورة القاتمة والمكثفة لسياسة التمييز الطائفي المفروضة على الشيعة في المنطقة الشرقية، هي صورة ممتدة الى لحظة إقامة الدولة السعودية وحتى الآن. ورغم أن حواراً أو مصالحة بدأت في سبتمبر 1993 بين المعارضة الشيعية ممثلة في الحركة الاصلاحية والحكومة بهدف إغلاق الملف الشيعي بكل ما يشتمل عليه من معاناة تاريخية واضطهاد طائفي في المجالات الواردة ذكرها سلفاً، الا أن الوعود التي منحتها الحكومة للممثلين عن المعارضة الشيعية لم تغلق الملف فحسب بل أضافت اليه بعداً آخر خطيراً، وهو إنهيار الثقة في جديّة الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشكلات المواطنين، حتى باتوا لا يرجون منها فرجاًَ ومخرجاًَ.
إن أوضاعاً ضاغطة كهذه من شأنها تكسير الروابط الداخلية والتسبب في انفصام العرى بين سكان هذا البلد والدولة، وحينئذ لا يصح رفع البطاقة الحمراء في وجه الشيعة وإتهامهم بعدم الانتماء الى البلد، أوالتشكيك في ولائهم للدولة، والسؤال الصحيح ماذا قدّمت الدولة لهم كيما تضمن ولاءهم؟ والجواب أولاً وأخيراً يكمن في أسس المواطنة التي لم ترس حتى الآن.
لهذا كله.. يجب أن تتحول قضية اضطهاد الشيعة الى قضية وطنيّة مسؤول عنها كل أبناء الوطن.. مثلها مثل القضايا الأخرى التي قد تهدد بشروخ في الدولة غير قابلة للجبر. إن الدفاع عن المضطهد أياً كانت انتماءاته المذهبية او المناطقية أو القبلية هو دفاع عن النفس أمام تغوّل الإستبداد السياسي والديني، وإلا يكون مصيرنا ومصير كل الإصلاحيين مثل الثور الأحمر الذي أُكل يوم أُكل الثور الأبيض. لا يجب أن يقبل دعاة الإصلاح بالحيف الذي قد يصيب مجاميع من رموز وأعضاء التيار السلفي، وإلا فقدوا صفة الإصلاح وصفة الوطنية معاً، ولا يجب أن يتركوا الفئات المهمّشة في شمال وجنوب المملكة تنافح عن نفسها أمام سلطة طاغية وتيار متطرّف، كما يجب على هؤلاء جميعاً أن لا يتسامحوا مع اضطهاد آخرين بنزع الصفة الإسلامية عنهم، وتكفيرهم والإفتاء بقتلهم لمجرد أنهم مخالفين مختلفين في الفكر والرأي.
لا نستطيع إنقاذ أنفسنا فرادى بل مجتمعين. وفي حال التخلّي في الدفاع عن المضطهد بيننا فإننا نسوّغ له ونفسح الطريق أمامه ليبحث عن العون الخارجي الذي قد يفضي الى تمزيق الوطن بأكمله.
تم ارسال رسالتك بنجاح