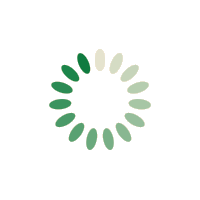
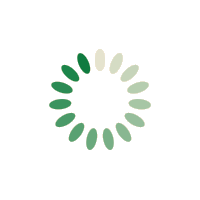


الإندماج الوطني.. هواجس وخيارات
(حالة الشيعة في السعودية)
د. فؤاد ابراهيم
دمغت العلاقة بين الشيعة كما أغلب المجتمعات والمناطق المنضوية داخل الدولة السعودية الحالية بحزمة توترات مع فترات مستقطعة كانت مشوبة بالحذر الشديد او الاسترخاء المحاط بالريبة. ويرد أحد المصادر الرئيسية لتوتر العلاقة بين الشيعة والحكومة الى اختلال التوازن في معادلة السلطة، أي في الطريقة التي تمت بها ترتيب علاقة الاطراف بمركز السلطة قرباً وبعداً، والتي تندرج في موضوعة الاندماج الوطني.
واستهلالاً يمكن القول بأن الاخفاق الذريع الذي منيت به سياسات الدولة في تحقيق الاندماج الوطني الشامل لم يكن وحده المسؤول عن تهميش الشيعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فهناك أيضاً عوامل أخرى ساهمت في إعاقة عملية الاندماج. في المقابل، لم تكن الاملاءات العقدية لدى الشيعة الآمرة بالانفصال عن النسيج الاجتماعي ومقاطعة السلطة الدنيوية الغصبية ضرورة امتثالاً لمبدأ الخلاص وتمهيداً لظهور المخلّص، إذ لم يهب الشيعة أنفسهم لرهان الايمان وحده بتعبير باسكال، فثمة قوى دافعة نحو الابقاء على القسمة الداخلية والحيلولة دون نجاح الانصهار الثقافي والاجتماعي وتالياً السياسي.
بكلمات أخرى، لم يكن التناقض الامكاني بين ايديولوجية الدولة وسلوكها السياسي وحده المسؤول عن استحالة الفصل في المنازعة المتواصلة مع الشيعة وباقي الجماعات التي تشعر بفداحة الخسارة في مشروع الدولة السعودية، فالفصل بين المبادىء والوسائل بات مألوفاً في العمل السياسي، فالآخر (الشيعي والدولة معا) يتحمل جزءا من المسؤولية، فالمثوي في مخزون كليهما سواء العقدي منه او السياسي يظل محرّضاً نشطاً على تنضيد النزوعات الايديولوجية مع أن الاستجابة لضرورات اللحظة لا تفقد مفعولها أيضاً حين تنشق عن أهداف مأمولة وآمان قابلة للنيل.
ما نحاول افراغ الجهد فيه هنا هو تقديم قراءة متوازنة لاشكالية عويصة مازالت غير محسومة وهي الاندماج الوطني الذي لا ينحصر بوجه خاص في الشيعة، وإن كان المثال الشيعي هو أبرز واخطر تمظهرات أزمة الاندماج الوطني، كون تهميش الشيعة في المستوى السياسي بدرجة أساسية كان قراراً مؤسساً على قاعدة دينية بدرجة أولى، ويمتد بإمتداد عمر الدولة وربما قبل ولادتها أيضاً، حيث كانت الدوافع الدينية المحرّضة على تخفيض الشيعية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً مؤصلة وراسخة. ليست النية هنا معقودة او مبيّتة من أجل استدراج القارىء الى المشاركة في تسجيل شهادة إدانة ضد الدولة وإخلاء مسؤولية الآخر ـ الشيعي من هذه المهمة المشتركة، فالنزوع الى ابراء الذمة الخاصة يبقي اللثام ملفوفاً حول خفايا وجوانب لا يجوز اغفالها. على أن ثمة قلقاً معرفياً يجب حضوره في القراءة المتوازنة حتى لا يجرنا الى قلب الحقائق أو تكسيرها من اجل الوقوف في منتصف خط متعرج أو شديد الاعوجاج.
الاندماج الوطني وإن كان مهمة على عاتق الدولة، الا أنه أيضاً محكوم بشروط داخلية شديدة التعقيدة وفي الوقت نفسه تفاعلات ثقافية واجتماعية، سيما حين يجري الحديث عن أطراف عدة يراد إدماجها في مصهر توليفي وصولاً الى انتاج مشتركات عامة: وطن، هوية، أمة، ثقافة عامة، روح مشتركة. فما لم تتواطأ الاطراف كافة على الانخراط في مشروع الاندماج، فإن قسمة الغنيمة (= الدولة) تصبح ملهاة، ويصبح الكلام عن حيف واقع على طرف ما قرر في الاصل عزل نفسه ومن يلوذ به طوعاً بلا طائل.
تأسيس الدولة: الاندماج او الإندراج
إن نقطة البداية المفزعة التي يجب تسجيلها تدور حول الاسس الذي قامت عليها الدولة السعودية والآليات التي جرى التوسل بها من أجل تشييد بنى الدولة وارساء جهازها الاداري وصياغة سياساتهاً. فمن نصوص مستفيضة وردت في الاضبارات الدينية والتاريخية الخاصة بمشروع التأسيس يتبدى أن الدولة السعودية قامت على عقيدة خاصة ودوافع خاصة، وجاءت المحصلة النهائية كتعبير أمين عن تلك العقيدة والدوافع. فالدولة السعودية الحديثة هي، وفق هذا التحليل، ليست منتج أمة، وفي الوقت نفسه ليست تجسيدا مادياً للوطن، فهذه الدولة لم تكن قائمة في الاصل قبل عام 1932، وانما ولدت على أنقاض أو بالاحرى عقب تدمير عدة امارات (جبل شمر، والحجاز، والاحساء، الادارسة في الجنوب). وهذا يعني، بوضوح شديد، أن الدولة السعودية لم تكن حاصل إجماع داخلي بين مجتمعات ومناطق تم الحاقها عن طريق القوة الغاشمة في بنية الدولة الناشئة.
وهنا تنشأ الاشكالية المركزية: علاقة مركز السلطة بالاجزاء الملحقة، ومن هنا أيضاً يتم تعريف هذه العلاقة إن كانت اندماجية أو إدراجية. بمعنى أن العلاقة لم تؤل الى انضواء الاجزاء كافة في كيان سياسي عقدي، أي قائم على العقد الاجتماعي، كيما يتبلور لاحقاً في دولة ذات حكومة تمثيلية representative government، أي تمثّل الاجزاء في المركز، وتحديداً في الجهاز الاداري للدولة، وصولاً الى انجاز عملية ادماج حقيقي للاجزاء في بنية الدولة الناشئة، وتالياً خلق هوية وطنية عامة تستمد مكوناتها من عملية صهر معقدة وواسعة النطاق لهويات خاصة. فقد تمدد المركز الى الاجزاء وفرض سطوته عليها ادارياً، فتمت عملية تذويب للاجزاء تحت وطأة الحضور الكثيف للمركز في التركيبة الادارية للاجزاء الملحقة، وفي نظمها الثقافية والاجتماعية والقانونية، وتالياً فرضت الدولة هوية خاصة مؤلفة من مكونات الجماعة المهيمنة، وفي نهاية المطاف أسبغت الدولة الجديدة هويتها الخاصة الثقافية والدينية والسياسية على مجمل الرقعة التي تتمسرح عليها في عملية محو شامل للتنوع الثقافي والمذهبي والاجتماعي.
في التحليل النظري لما نجم عن الصيرورة التاريخية لتشكّل الدولة يصبح الجدل على هذا النحو: في حال أرادت دولة ذات سيادة ضم أكثر من جماعة ذات خصائص ثقافية متميزة كما هو الحال في كافة الدولة الحديثة، فإن ثمة ثلاثة أنواع مثالية من الاندماج كما يحددها Edmund Leach:
1ـ الاندماج الكامل: إن الايديولوجية الهادية لمثل هذا النوع هي أن الدولة تنزع الى تحقيق الانسجام الثقافي التام بداخلها، وهذا يتطلب سيادة ثقافة الجماعة المهيمنة سياسياً. وتفترض هذه الايديولوجية بأن قيم الاقلية وعادات الاقلية ينظر اليها بوصفها تهديداً ازاء التضامن المتماسك للمجتمع ولذلك لابد من ازالتها.
ان المحرّض الحقيقي على الامتثال لخيار كهذا يصدرعن عقيدة تنزيهية شمولية ترى في الانعتاق العقدي للأقلية شرطاً نهائياً وغير قابل للمساومة من أجل الحصول على إذن الدخول في شراكة سياسية. لا تصدر هذه الايديولوجية عن مجرد رؤية دينية يقينية وحدها بل هي تتظافر مع نزوع سياسي شديد الضراوة لدى المؤسسة الحاكمة.
في حالة السعودية، ساهم العامل الديني/ المذهبي، الى جانب مدعى الحق التاريخي من بين عوامل اخرى قليلة، في تشكيل هوية الدولة وأضفى طابعاً خاصاً على برامجها الثقافية وايضاً انعكس على سياساتها العامة ونظمها الادارية والقانونية، وعلاوة على ذلك أصبح ضابطاً رئيسياً في العلاقة بين الدولة والمجتمع، كما فرض نفسه كمعيار في نظرة الحكومة الى المواطنين. يلحظ Lewis W. Snider بأن ثمة رابطة وطيدة بين هوية الدولة ودين وثقافة الجماعة الغالبة التي تضفى بلا مناص مكانة سياسية منخفضة للاقليات الدينية والاثنية.
فالنجاح الباهر في توحيد منطقة نجد تحت تأثير العامل الديني لم ينسحب الى المناطق الاخرى، حيث كان لهذا العامل مفعول سلبي للغاية وبالاحرى تقسيمي، إذ أن الاستعمال الكثيف للخطاب الديني بنفس العنفوان المشحون بداخله والذي تدين له نشأة الدولة، لم يتم تخضيده كيما يفسح الطريق امام مشروع الوطن أن يرسي أسسه مستمداً مكوناته من المجموعات الجديدة التي ألحقت بالدولة الناشئة. ما جرى في واقع الأمر أن مكونات الخطاب ما قبل التأسيس وبعده ظلت متماسكة ونشطة بكامل طاقتها التحريضية، وإذا كانت هذه المكونات صلحت في إقامة الدولة فإنها بالتأكيد أخفقت في صناعة وطن، لأن المرحلة الاولى تطلبت إنشاء مجتمع مضاد ينشق عن المجتمع السائد ليتم الانقضاض عليه من أجل تاسيس الدولة، ولكن في مرحلة بناء الوطن فإن ثمة شروطاً جديدة وعوامل مختلفة من أجل الشروع في عملية ادماج واسع النطاق كيما تلتقي الدولة بالوطن. ولكن حتى الآن فإن الدولة بقيت دولة ممثلة في جهاز اداري يستحوذ فيه العنصر النجدي على نسبة 78 بالمئة فيما تتمثل فيه الحجاز بنسبة 17 بالمئة وللمناطق الاخرى 5 بالمئة فقط، حسب أطروحة محمد بن صنيتان. وهنا نستعيد ما قاله أدغار موران حول تظافر عنصري التملك الاحتكاري للحقيقة والضبط الاستبدادي لكل قطاعات المجتمع وأجزائه، حيث ينتج بتفاعلهما معاً نسج وجه السيطرة الجديدة من جانب الجهاز المنتج ذاتياً.
وفي سياق الانشغال الحثيث بمركزة الدولة في تواصل مع تهميش سياسي للأطراف الملحقة تطرح مسألة الهوية الشيعية. فالجماعة الشيعية إنتبذت مكاناً قصيّاً في البناء الاجتماعي للدولة كرد فعل على الاحساس بالخطر الايديولوجي ابتداءً ثم التحم بمشاعر الانزواء بفعل العزل السياسي المنظّم، لينجم في وقت لاحق عن انفصال جماعي نفسي وثقافي وسياسي داخل الدولة لجماعة وجدت نفسها ضحية حرمان سياسي وإضطهاد ديني. هكذا يحلو للاستبطان الشيعي أن يصيغ مبرر الاعتزال مسنوداً بالمسوغات العقدية والتاريخية التي أملت على الفرد الشيعة اللجوء الى خيار الاستقالة أسوة بتفسيرات مبتسرة لروايات باطنية وتجارب مستمدة من التاريخ الثاني، أي التاريخ المتخيل، الذي لم يقع. فسيرة الاضطهاد السياسي في تاريخ المسلمين والذي كان فيه الشيعة ضحايا افتراضيين يمثل لدى قطاع من الشيعة الى ما قبل الانبعاث الشيعي في نهاية السبعينيات مصدري إلهام وإيهام، فهذه السيرة نشّطت من جهة طاقة التحريض الثوري لدى طائفة من المصلحين الشيعة من أجل تعديل السيرة وقلبها، فيما شكّلت لدى قطاع آخر منهم منطلقات تسويغية لتبرير الانطواء على الذات والعيش في القادم المنتظر.
بالنسبة لشيعة السعودية، فقد كان الموقف السائد يترواح الى ما قبل سنوات قليلة بين الاستقالة والخيار الثوري، وفي كلي الخيارين تغيب العلاقة مع الدولة، ففي الاول تقرر اعتزال الدولة انتظاراً لقدوم المصلح، وهذا الخيار لم يكن رد فعل على نشأة وسياسة الدولة السعودية بل هو مجبول عقدي أصيل في البناء العقدي الشيعي، وفي الثاني تقرر الاطاحة بالدولة طمعاً في اقامة البديل الديني الشرعي، المنمذج إيرانياً.
لا ريب أن فشل الدولة في بعث الطمأنينة في نفوس الجماعات والمناطق التي باتت تحت سلطانها لم يسكّن مشاعر القلق ولم يخفف من تأثير العقائد في توجيه السلوك العام لديها. فقد ظل الاحساس بالخطر من التلاشي في الآخر يدفع الشيعة لمزيد من التكتل، والعزلة. أي أن الشعور بالخطر لدى الشيعة كجماعة دينية مهددة من قبل المجتمع الديني الوهابي دفع بهم لتعزيز التحصينات العقدية والاجتماعية لمواجهة خطر الاضمحلال مذهبياً ومادياً أيضاً.
وقد لعبت الطبيعة دوراً مزدوجاً في سياق العلاقة بين الشيعة والدولة، حيث ساهم اكتشاف منابع النفط في المناطق القريبة من المدن الشيعية لجهة تركيز الوحدة المسكونية للشيعة، إذ أوجدت الصناعة النفطية فرص عمل لأفراد الطائفة الشيعية وأسقطت خيار الهجرة لأسباب اقتصادية الى مناطق اخرى. إن تمركز مصادر الثروة في المنطقة الشرقية كان له إنعكاسات متضاربة، فمن جهة أضعف فرص الضغط الاقتصادي عليهم من قبل الدولة. بالرغم من الاحساس المتعاظم بالحرمان الاقتصادي لدى الشيعة.. الا أن استعمال السلاح الاقتصادي ظل دائماً محكوماً لحاجات الدولة والظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الشرقية، إذ لم يكن بإمكان الدولة ان تسمح للاختلالات الامنية في منطقة حيوية ان تعطّل حركة الاقتصاد الوطني القائمة على اساس ما يجلبه النفط من اموال لتسيير كافة قطاعات الدولة. ولذلك فإن الشيعة ظلوا رغم التخفيض المتواصل لحصتهم في قوة العمل في الصناعة النفطية على امتداد العقدين الماضيين عنصراً استراتيجياً في عدد من الدوائر الحيوية في هذه الصناعة.
في المقابل، إن انخراط الشيعة في الصناعة النفطية أفضى الى حرمانهم في الاندماج بالمعنى الواسع أي السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الاقتصادي، فقد بقي الشيعة جماعة معزولة، وجاءت عزلتهم متوازية ومنسجمة مع سياسات الدولة ذاتها التي لم تكن تنطوي على محفّزات نحو الاندماج. يضاف هنا أيضاً أن الاحساس بالخطر لدى الشيعة كان يحول دائماً دون انتقال بعضهم للعيش في مناطق مأهولة بأغلبية سنيّة وبخاصة وهابية في ظل مناخ ديني مشحون بالعداء الحقيقي أو المتخيل ضدهم، الامر الذي يفرض عليهم العيش في خوف دائم وهكذا غرباء عن النسيج الاجتماعي العام. وكرد فعل على أوضاع كهذه سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية، فإن الشيعة يشعرون في مناطقهم بالألفة والطمأنينة التي يفقدونها فيما لو قرروا العيش في مناطق أخرى، وهذا ما يضفي معان محددة على الاقليم الذي نشأوا عليه، وهذا من شأنه أن يبعث ميولات من نوع ما لدى بعض الشيعة، وهو ما يثير مخاوف لدى الحكومة من تحوّل المنطقة الى قاعدة انشقاقية عن الدولة، وقد يحظى هذا الخوف بإهتمام خاص لدى صانعي الاستراتيجيات في الغرب، وفي الولايات المتحدة بخاصة.
لاشك أن التضامن الطائفي قد ولّد مخاوف ومشاكل سياسية حقيقة للدولة، فمن الطبيعي ان تقدح التضامنات الجماعية صراعاً سياسياً، كونها تشدد على أهمية ومركزية الهوية الاقلاوية والولاءات الفرعية في مواجهة الدولة ومحاولاتها لاضعاف هذه التضامنيات او التعايش معها او منافستها.
وعلى أية حال، فإن مسعى الدولة نحو الاستيعاب الكامل للجماعات يواجه مقاومة عنيدة من هذه الجماعات وخصوصاً منذ انطلاق العصر القومي ومبدأ حق تقرير المصير، إذ لم يثبت حتى الآن أن هناك مثالاًَ واحداً على الاستيعاب التام من قبل جماعة سياسية أو اثنية لجماعة اخرى.
على الضد من ذلك، فهناك دلائل عديدة تؤكد على أن هويات الاقلية قد تتحول الى قوة تدميرية مهددة الدولة، ما لم تتمكن الاخيرة من تخليق بدائل اخرى تؤدي الى تحييد التأثيرات الاجتماعية والسياسية للهوية، وقد يكون خيار المشاركة السياسية علاجاً ناجعاً لامتصاص المكنون الاحتجاجي الداخلي للهوية. وعلى أية حال، فمن الطبيعي ان تنمّي الاقليات مشاعر الانفصال بمرور الزمن في تواصل مع اخفاق الدولة في سياسة الادماج، تماماً كما تنشأ هويات مستقلة وربما انفصالية في حال عجزت الدولة عن تطوير هوية وطنية جامعة. وهذا لا يعني مطلقاً بأن وجود أقلية غير منصهرة في بناء الدولة يعني بالضرورة تهديداً لسيادة الدولة وتماسكها، ولكن وجود أوضاع معينة كالتي في السعودية حيث الوحدة الوطنية هشة وغياب ثقافة وطنية جامعة يشجّع على نمو مشاعر الاستقلال.
في المنظور السياسي العام، فإن ثمة عائقاً رئيسياً في الاستيعاب وفي بعض الحالات في التعايش السلمي وهو الطريقة التي تعرّف فيها الشرعية السياسية في كثير من دول الشرق الاوسط. فالنظام السياسي الشرعي على حد مايكل هدسون: يتطلب احساساً متميزاً بالذاتية التعاونية: فيلزم أن يشعر الشعب داخل الاقليم باحساس المجتمع السياسي الذي لا يتعارض مع التمثلات الجماعية فوق الوطنية او المتفرعة من الوطن. فاذا تم ادراك التضامن الجماعي المتميز بوصفه المحور الافقي الضروري للنظام السياسي الشرعي، فستكون هناك رابطة عمودية قومية وسلطوية بين الحكام والمحكومين. وبدون هياكل سياسية سلطوية تتمتع بالحق فإن الحياة السياسية تكون من المؤكد عنيفة وغير متوقعة.
2 ـ الاتحاد الفيدرالي: وهذا النوع مؤسس على الفلسفة الهادية الى التسامح، إذ من المطلوب منا قبول الاطروحة القائلة بأن بالامكان تحقيق المساواة بين الناس حتى لو كانوا مختلفين. وبطبيعة الحال، فإن فكرة الفيدرالية ذات جاذبية خاصة لدى ذوي الميول الليبرالية، مثال ذلك سويسرا التي تحتضن تنوعاً ثقافياً مع فيدرالية سياسية أثبتت بأنها إمكانية مرئية ناضجة والتي استمرت لقرون عديدة.
ولكن الصعوبات العملية في هذا الصدد عديدة وإن كانت معروفة، منها أن تنزع وحدة ثقافية ما الى السيطرة على باقي الوحدات. وبديل ذلك أنه في حال وجود مجموعات عدة فإنهم يكيِّفون أنفسهم داخل نظام تراتبي محدد، ولكن هذا النظام يفضي في نهاية المطاف الى الاستغلال. مع الفات الانتباه الى أننا من الناحية العملية نعيش في مجتمع مؤسس تراتبياً حيث أن الطبقات الاقتصادية متميزة ثقافياً ولكن بدرجات مختلفة.
وكثيراً ما حظي خيار كهذا بقبول لدى غالبية المناطق الملحقة بالدولة السعودية، من أجل تفتيت الاحتكار السياسي للمركز. إن اشاعة جو من الطمأنينة والتسامح يتطلب خياراً مرضياً للاطراف كافة، ويؤدي أيضاً الى اعادة التوازن داخل الدولة وإن تطلب ذلك إعادة تأسيس الدولة على أسس مختلفة قد تطال الايديولوجية المشرعنة لها. إن نقل أجزاء من السلطة من المركز الى الاطراف يعتبر الخيار الأمثل لتحقيق فكر الاندماج الوطني مع ما ينطوي عليه من مخاوف، من قبيل تشجيع النزعات الانفصالية. الا أن مفعول هذه النزعات تكون ضئيلة في المناطق التي لم تتعزز فيها النزعات الانفصالية بعكس حالة الاكراد في العراق وتركيا، لأن إعتماد الخيار الفيدرالي في مرحلة متأخرة قد يؤدي الى انهيار الدولة وتفككها. وعلى أية حال، فإن ثمة إجراءات احتياطية تتبعها الدولة من أجل دحض النزوعات الانفصالية من خلال آليات معروفة، عن طريق تشجيع الثقافة الوطنية، واقامة حكومة تمثيلية مركزية فاعلة، وتوزيع مصادر القوة والثروة وغيرها.
الثالث: التعايش المنفصل: لقرون قليلة مضت عاشت أغلبية شعوب العالم بأسره في مجتمعات مكتفية ذاتياً من الناحية الاقتصادية جرى تكييف أوضاعها من خلال التكنولوجيا والمهارة التقليدية للبيئة المباشرة. ولكن هذه الانظمة الثقافية المتخصصة قد اختفت ولكن بعضها عاش في ظروف بييئة متطرفة مثل البدو في الصحراء، والامازونيين الهنود، وبقايا الثقافات القديمة في الاسكيمو، والابوريغين الاستراليين، وغيرهم، وفي هذه الانظمة الثقافية يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي قضية جوهرية. إن أي تفاعل قريب مع المجتمعات المجاورة يقود تلقائياً الى التدمير الثقافي واحياناً الى تدمير المجتمع الانساني ايضاً. في ظل الظروف المعاصرة فإن معظم هذه الاوضاع تتصل بمجتمعات صغيرة الحجم للغاية. ومهما يكن، فإن هذا الخيار يعتبر غير عملي وواقعي في ظل نظام دولي شديد التداخل والتفاعل.
ولكن ايحاءات هذا الخيار تنبّه الى أن جنوح السلطة السياسية المهيمنة والاستيعابية موجّه لتدمير الاقلية الثقافية من خلال عملية الاحتواء. ومن المعروف فإن الشيعة في السعودية كما هو شأن تجمعات أخرى قاوموا بنجاح كبير الاستيعاب المفضي الى الالغاء التام وهكذا التوترات السياسية الناشئة عنه. لقد صنعت الجماعة الشيعة في رد فعلها على التمييز الثقافي الداخلي بديلاً خارجياً تتفاعل معه وتتواصل مع مراكزه كتعويض عن الاحساس بالاغتراب وايضاً الهزيمة الداخلية.
ولذلك فإن تعريف المشكلة يبدأ من موقف الشيعة الاولي. اذا ما وافقت هذه الجماعة على الذوبان فلن تكون هناك مشكلة، ولكن ماذا لو أصرّت هذه الجماعة على الاحتفاظ بخصوصياتها الثقافية. وهناك مشكلة اخرى وهي: هل الاندماج او الاستيعاب قابل للقسمة؟. ففي بعض الاحيان، تقبل جماعة او جماعات معينة الاندماج والاستيعاب في النظام الاقتصادي، ولكنها تلحّ على حقها في تمييز نفسها باعتبارها جماعة دينية مستقلة. إن عدم تسامح المجتمع المحيط، قد يولد بدرجة كبيرة من عدم التناسق في سلوك الاقلية نفسها. فهل الشيعة قبلوا الذوبان الاقتصادي؟ ولكن بسبب مذهبهم الانعزالي نبذوا الذوبان الكامل؟
يلزم التذكير هنا بأن النفط قد عدّل وبصورة جد كبيرة العلاقة بين الدولة والمجتمع ليس في السعودية فحسب بل في الدول الخليجية النفطية. إن تأثيرات هذا التغيير وبخاصة في طبيعة المطالب السياسية المنبعثة من المجتمع تعتبر ذات أهمية خاصة. فمن جهة فإن الدولة كانت بحاجة الى اشراك قطاع كبير من الافراد في الصناعة النفطية التي تطلبت قوة عمل ضخمة وماهرة من اجل ادارة عملية انتاج وتسويق النفط. خاصة وأن منابع النفط متمركزة في المنطقة الشرقية ذات الاغلبية الشيعية، وتحديداً في المراحل الاولى اي قبل بدء نشأة المدن الحديثة (الدمام، الخبر، الظهران) التي اجتذبت مجاميع سكانية كبيرة من مناطق مختلفة من المملكة.
ولا شك أن التحوّل الاقتصادي في الدولة وانعكاسات الثروة النفطية على المجتمع والدولة وبخاصة في مجال التمثيل السياسي قد عبّر عن نفسه في المرحلة الاولى في الاضرابات العمالية في الخمسينيات والستينيات اي قبل الطفرة النفطية في السبعينيات والتي أخذت شكل (نقابات العمال) ثم (الغرف التجارية)، ثم في التشكيلات السياسية التي ظهرت في المنطقة محثوثة بدوافع أيديولوجية قومية وليبرالية واشتراكية ولكنها تنبض بالدعوة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي، وفي صياغة الدولة على أسس ديمقراطية.
ثمة حقيقة أخرى أن الدولة الريعية ظلّت محصّنة أمام ضغوط المجتمع لجهة حيازة دور في العملية السياسية، على أساس العقيدة السياسية التقليدية السائدة في الغرب (لا تمثيل بدون نظام ضريبي). وتقضي هذه العقيدة أن حاجات الحكّام الى تحصيل الدخل من المجتمع عبر الضرائب وحق المجتمع في تقييد الحكام عبر الانتخابات والسلطات التشريعية. وحيث أن الدولة الريعية ليست بحاجة لفرض ضرائب على مواطنيها، فإنها في المقابل ليست بحاجة لتلبية المطالب الشعبية للمشاركة. ولذلك، فإن القوى السياسية التي كانت تضغط من أجل التغيير السياسي والمشاركة في نظام الحكم قد تم تهميشها بسهولة، لأن ثمة تواضعاً على أن المال قادر وبفعالية كبيرة على اخماد الميول السياسية الطموحة واطفاء الرغبة في المنافسة للحصول على حصة في الحكم.
إن هذا الوضع يصدق تماماً على الفترة ما بين 1970 و1990 حيث كانت سطوة الدولة الريعية تحول دون الاستجابة لأي نوع من المساومة الداخلية والتنازل عن جزء من السلطة أو القبول بمبدأ المشاركة. ولكن منذ انفجار أزمة الخليج في الثاني من أغسطس 1990 بدأت حركة مطلبية واسعة النطاق من منطلقات أيديولوجية وسياسية متنوعة من أجل وضع دستور شامل للدولة وتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل السياسي واجراء اصلاحات شاملة في النظام القضائي والتعليمي والديني.
إن موضعة النشاط المطلبي في هذه المرحلة في سياق الاندماج الوطني يعين على فحص الاتجاهات الشعبية العامة في هذا البلد. فهو يمثّل أحد المؤشرات البارزة على الرغبة الجماعية نحو تحقيق الاندماج السياسي من منطلقات مختلفة. ولم يكن الشيعة نتوءا نافراً في الحركة المطلبية التي انطلقت في التسعينيات، بل مثّلوا جزءا من الرهان الشعبي العام على التغيير السياسي وتغيير بنية الدولة.
هواجس الدولة وخياراتها
اليوم هناك ثلاث استراتيجيات تتبعها الدولة في التعامل مع الشيعة:
الاولى: قد تلح الدولة على استيعاب العناصر المقاومة المنبثة والكامنة داخل الجماعة الشيعية. ربما يتذكر الباحثون ما جرى في حالة أقليات مثل البروفنشال والبريتونز الذين كانت جنسيتهم الفرنسية مشروطة بالتخلي عن لغاتهم المحددة وعلامات حدودهم والذين بدأوا بصورة تدريجية بتعريف أنفسهم باعتبارهم شعباً فرنسيا. ولكن هذا المقال في السياسات الاستيعابية الناجحة أدى في نهاية المطاف الى اختفاء الاقلية، كما جرى بالنسبة لمصير الكورنيش في تاريخ بريطانيا حيث يتميز المتحدرون منهم عن الانجليز. الا أن حالة الشيعة هنا تبدو مختلفة حيث أن الدولة قد تعتمد برنامج استيعاب جزئي للشيعة، عن طريق احتضان بعضهم داخل بنية الدولة، ومع ذلك فإن هذا البرنامج يواجه تحديات كبيرة كون التشيع صنع بداخله نظاماً دفاعياً حصيناً يصعب اختراقه بسهولة، ولذلك فإن نجاح فكرة الاستيعاب يبدو مستحيلاً وخصوصاً في الظروف الحالية التي فقدت الدولة فيها جزءا كبيراً من هيمنتها السياسية وتأثيرها الثقافي فضلاً عن الانكسار الحاد الذي ضرب مصادر القوة الايديولوجية للدولة منذ الحادي عشر من سبتمبر.
الثاني: أن الدولة قد تميل الى الهيمنة، والتي تعني غالباً التمييز، وهذا يقتضي أن تتم ازالة الاقلية عملياً من الاغلبية، وهذا يبرر غالباً من خلال ذريعة التدني الثقافي المتخيّل للاقلية. على أية حال، إن واحدة من آليات الرفض تجريد الآخر من الأهلية، فالدولة حين ترفض مبدأ الاندماج فهي تكون أحياناً قد قررت سلب الجدارة وتالياً الحق في المشاركة السياسية. إن الرفض يتخذ غالباً شكل الازدراء الاخلاقي والرفض العقلي. فتجريد الأهلية يؤول الى تجريد الجدارة والحق، وهذا ما ينطبق على موقف المؤسسة الدينية الرسمية من الشيعة، ولذلك فإن أية مطالب شيعية تقابل بالرفض حين يتعلق الأمر بممارسة حق التعبير عن المعتقدات الخاصة أو التمثيل السياسي للجماعة.
ومصدر هذه الاستراتيجية يرد الى حقيقة أن ايديولوجيات التمييز تؤسس على فكرة أن ثمة ضرراًَ من الثقافات المختلطة أو العروق وأنها شديدة الاهتمام بصيانة الحدود ليس الجغرافية فحسب بل والثقافية والاجتماعية. ويبدو صحيحاً تماماً بأن التمييز ليس بالضرورة ناشئاً عن سياسات مقررة من الدولة ولكن نتيجة تظافر تباينات طبقية باقتفاء خطوط إثنية، وانقسامات إثنية والاحساس بعقدة الاقلية.
الخيار الثالث: يتألف من ايديولوجية وطنية تعلو فوق الانتماءات الخاصة والهويات الخاصة وتبني ايديولوجية التنوع الثقافي حيث المواطنة والحقوق المدنية الكاملة لا تتطلب هوية ثقافية خاصة، أو نموذج فيدرالي غير متمركز يقدم درجة عالية من السيادة المحلية.
الشيعة بين هواجس الماضي وخيارات المستقبل
من الناحية النظرية فإن الاقليات تكون لها ردود فعل على هيمنة الدولة في ثلاث اتجاهات وهي: الخروج (الانفصال)، صوت (المعارضة والاحتجاج من اجل التمثيل)، أو الولاء.
الخيار الاول: الاستيعاب والانضواء، وهذا خيار عملي لا يخضع لإباء الجماعة او إرادتها، وفي الغالب فإن هذا الخيار ليس رهين مفاضلة من أي نوع. في بعض الحالات من المستحيل بالنسبة لبعض الاقليات اختيار الاستيعاب والانضواء. فالسود في الولايات المتحدة لم يتم استيعابهم بسبب اللون (العرق) باعتباره مائزاً هاماً للاثنية في الولايات المتحدة، فلون الجلد يصبح خاصية إثنية سواء أضفى السود عليها أهمية ام لا.
وعلى أية حال فإن الاقليات التي عادة ما ترفض الاستيعاب يكون لديها موقع منخفض في قطاع العمل، وقد يصنّفوا بناء على ذلك كضحايا للتمييز الطائفي أو الاثني. وهناك جماعات اخرى قد تقاوم بصورة فاعلة الاستيعاب وتستجيب لبعض جوانب الإدماج. ومهما يكن فإن التاريخ السعودي الحديث يكشف بأن سياسات الدولة وردود فعل الشيعة انتهت الى مقاومة عنيدة لمبدأ الاستيعاب.
الخيار الثاني: التعايش مع الحالة المتدنية، أو الدونيّة (subordination) اي بكلمات اخرى محاولة التعايش بسلام مع الدولة القومية. وقد تلجأ احياناً الاقلية الى التفاوض من أجل سيادة او سلطة محدودة في الشؤون الدينية واللغوية والسياسة المحلية مثلاً، وهذا ينطبق على الشيعة في المنطقة الشرقية حتى بداية الثمانينات، ثم تطوّرت الحركة المطلبية مع ظهور حركة سياسية تناضل منذ التسعينيات من أجل حصة في السلطة المركزية وفي الادارة الاقليمية.
الخيار الثالث: الخروج والانفصال وهو خيار نهائي تلجأ اليه الجماعات التي استنفذت خيارات الحلول المقترحة من الدولة ولم تجد سوى البتر حلاً حاسماً لمشكلتها. وعلى أية حال، فإن الجماعات التي تفضل خيار الانفصال والاستقلال التام عن جسد الدولة هي دائماً جماعات إثنية ـ عرقية. ولربما لا ينطبق هذا على الشيعة باعتبار ان الخصائص التقليدية للجماعة الاثنية لا تنطبق عليها. تبقى الاشارة الى أن ثمة مقترحاً لدى Arend Lijphart يقول بأن الخيار الأمثل لأي حكومة لمنع النزعة الانفصالية ليس في مقاومتها مادياً وانما في المشاركة في السلطة بصورة عادلة وفاعلة. ويذكر أهم خاصيتين للمشاركة في السلطة هما مشاركة ممثلين عن الجماعات الكبيرة في حكومة البلاد ودرجة عالية من السيادة لهذه الجماعات في المناطق التي تقطنها. وهناك خاصيتان ثانويتان هما: التناسبية (من نسبة) وفيتو الاقلية. إن ذلك كله يهدف الى تحقيق فكرة أن المشاركة في السلطة تعني الممارسة المشتركة في الحكومة من قبل مجموعات عديدة تمثل الطيف الكامل والمتنوع للمجتمع، بما يشبه حكومة ائتلافية واسعة في نظام برلماني.
تبقى هذه الخيارات كلها محكومة برؤية الدولة الى الشيعة: هل تنظر إليهم باعتبارهم مصدراً للمتاعب وبؤرة اضطراب ومشاكل، مع الفات الانتباه الى أن هناك العديد من الدول تعامل الاقليات بصورة متميزة. فبريطانيا مثلاً مديونة في كثير من انجازاتها الى الجهود المبذولة من قبل أقليات ساهمت في نجاحها واستقرارها. هل الشيعة كانوا فقط مزوّد عمالة للصناعة النفطية في وقت سابق، أم أن لهم دوراً آخر لم يتم استغلاله بشكل أفضل؟
لا شك أن السماح للشيعة بمزاولة شعائرهم الدينية الخاصة يثني الميول الانقسامية عن الانبعاث كما يشجّع على الاندماج في الثقافة المحلية والوطنية وفي الوقت نفسه يخفف من وطأة الوعي العقدي الضاغط من اجل الارتداد نحو مخزون المذهب كيما يوجّه مواقف وسلوك الافراد، ولكن تحقيق مبدأ الاندماج الوطني يتطلب جهوداً أكبر من ذلك من جانب الدولة والشيعة معاً.
تم ارسال رسالتك بنجاح